رائحة .. أكاد لا أصدق كيف لوردة مجففة بكامل ذبولها أن تنجو داخل حقائب السفر محافظةً على أوراقها بعد رحلة عناء طويلة من دمشق مرورآ بالقاهرة ثم غزة فالقاهرة مجددآ وصولآ إلى السويد.
حواجز .. معابر .. أنفاق .. حدود .. مطارات و عشرات المحطات و أنا لا أتمسك بشيء أكثر من حقيبة بحجم الحقائب المدرسية تحتوي على أوراق مصنفة و بعض التذكارات و على كمية هائلة من الحب.
الآن أجلس و أمامي وردةٌ لا أعرف أكثر من أنها وردة! من مخيم اليرموك إلى هذا الشمال قبل سنوات أربع.
و أيّآ يكن، فأيَّةُ عاشقٍ رديءٍ كان ليحددَ نوعَها. أيُّ بائعةِ هوىً كانت لتعرفَ لونها الطبيعيّ. و أي أحد – على ألا يشبهني – كان ليميز رائحتها الأصلية أو يعرف إسمها على الأقل .. أذكر ما كان بعد المخيم إذ غادرناه إلى ملجأنا في معهد دمشق المتوسط /VTC سابقآ/ و كالكثيرينَ بدون متاعٍ يُذكر، إلا أوراق و مستندات شخصية. بالإضافة إلى من لديه مال و مجوهرات ثمينة سهلة الحمل.
و حيث أني لم أمتلك شيئآ من شأنه عمومآ أن يضعني في مواقف لا يحمد عقباها؟ كأوراق زواج أو ملكية أو نقود أو جواز سفر، كنت سباقآ لإخراج من في المنزل من أفراد أسرتي و إيصالهم إلى منطقة آمنة وسط العاصمة بالطريقة التقليدية التي كنا ننقل فيها البضائع أو ما شابهها من أشياء … و رأسآ .. كان عليّ المعاودة داخل المخيم في ذات اليوم “الميغ” لأسبابٍ كثيرة أَوْضَحُها لذاكرتي كان لجثث و أشلاء سقطت من باب عربة الإسعاف الخلفيّ أمام مشفى الشهيد حلاوة أرهبت قلبيَ الذي زادَهُ فزعآ صيحة مكبوتة أطلقتها والدتي من هول المنظر! و بعدها مكثت ليومين إضافيين و فهمتُ أن المسألة أكبر منا بكثير. و مجددآ عادت والدتي و أخرجتني مع أخواي من المخيم. و ليلة رأس السنة .. انشغل الجميع بإعداد شيء ما للإحتفال و جلب البهجة بالتعاون بين الأهالي و المنظمات القائمة آنذاك على مساعدة النازحين داخل المعهد الأشبه بحظيرةٍ مفتوحة و الأقرب إلى مَسكن إقامة جبرية! الغريب أنه سريعآ بات دخوله يتطلب قدرآ كبيرآ من الوساطة! بل و إنْ تعرض أحدٌ للطرد سيتوسل و يتوسل و إلا أرسلوه خارجآ إلى المدينة التي ليس فيها من يتجول مرتاحآ سوى الخطر.. ” هذا يوم التسلل إلى المخيم ” قلت لنفسي! الدخول و الخروج من السابعة صباحآ حتى الواحدة ظهرآ أو أقل. حيث مؤخرآ، في ذلك الوقت، لم تستغرق عائلتي وقتآ طويلآ لمناقشة السفر خارج البلاد لدواعي السلامة. و حيث أني لم أحبذ تلك الأحاديث معهم، إلا أن الخوف أدركني على أهم شيء أمتلكه – حتى اللحظة هذه – أنه بعيدٌ جدآ عني! إنه مجموع الأوراق التي كتبت عليها لسنوات عديدة. أسمّيها “قصائد جهينة”. لجهينة كتبت أول مرة في حياتي. لذلك، حسنآ! لا يمكن لها أن تنشر في أي مكان لشدة رداءتها، و لكن ما زلت أحفظ من أبياتها الكثير. الأوراق كانت محفوظة في غرفتي، على مكتبي الخاص و بين حاجياتي و أغراضي الكلاسيكية الكثيرة، داخل مصنّفَيْن إثنين من المصنفات المكتبية ذات القاعدة العريضة المستطيلة بحيث تترك فراغآ في الداخل على امتداد شكل موشوري يسمح بحفظ بعض الأشياء أستخدمه غالبآ لوضع الأقلام التي ما كنتُ لأُحِبَّ التخلص منها بعد فراغها. و هذه مجرد إجابة عن سفينة النجاة التي استقلتها وردتي الجافة! فلا أقسم بجهينة أني ما علمت بوجود وردةٍ داخل أحد المصنفات حينما دخلت إلى المخيم ليلة رأس السنة تلك و عدت بهم في اليوم التالي إلى سكننا في الملجأ. لم يكن أحد ليتركني أمضي بسهولة إلى تهلكةٍ لقاءَ كلماتٍ على ورق لو أخبرتهم برغبتي في الدخول. هذا.. و إننا كأسرة، كنا بحاجة الكثير من المستلزمات الضرورية التي لم نتحصل على وقت لإخراجها، لذلك لم يحدث أن راجعت نفسي بتلك المخاطرة التي استسلمت فيها تمامآ لما قد يصيبني. فجاء القرار بعدم التفكير مسافة الطريق حتى بلوغ الحاجز. لا أكذب حين أقول بقدرتي على إسكات التفكير، و لكن بالكاد أسمعه. و إلا كنت سأصف لكم تلك المخاطرة بأشد العبارات سخرية.. ثم وصلت البيت بلا عناء. هاتفت والدتي أن تجهز قائمة بما عليّ توضيبه، و طمأنتها بالطبع عني، ثم انصرفت إلى أمور كثيرة لا أستطيع نسيانها أبدآ كان من شأنها أن تغيّب عن ذهني صندوق الذكريات الذي يحوي ما تركته لي جهينة. أو ربما بسبب فكرة السفر أنها لم تكن مؤكدة!؟ أو لأن الصندوق في داخل خزنة متينة!؟ أو لأن التوتر كان بريئآ في البدايات!؟ من يدري … المشكلة، أني لم أجرؤ على فتح أي من المصنفين إلا في غزة و بعد أشهر من وصولنا! من ذا الذي يستطيع النظر إلى صورة الحبيبة دون أن تتساقط أمامه حياتُه المبنية على الحنين و خداعه ! من ذا يحتمل العطر المكنون الذي يَعْبَقُ المكانُ فيهِ لمجرد أن أفتحَ ورقة! ألم تكن جهينة تضع على كل قصيدة من عطرها و تعيدها إلي! على عشرات الأوراق الأخرى أصنافٌ من العطور و لا شيء في الدنيا يفوح مثل قصائدها.. فكذلك أحتفظ بالأوراق و لكن لا أقوى النظر فيها! أحيانآ أفكر أنني بهذا أطيل عمر الرائحة.. و رغم تعاقب النكبات و توالي الهجرات، و رغم الإنتقالات الكثيرة المريرة بين المنازل و البيوت واظبت بحرص لا أستطيع وصفه بالبالغ خوفآ من الكذب و الإبتذال على الإبقاء عليها بجانبي! و الشدة كانت في الإبقاء و لو على بقايا منها لسبب في الأعماق أبصر منه نورآ. فهي سهلة التفتت مثلي. و رغم كل ذلك ما زالت سليمة كأنها جفت أمس. سمراء اللون، مخملية.. لها بشرة داكنة كالخال على ثغر جهينة. على خصرها برعمان تفتحا أولَّ الجفاف … و محنيةٌ كزهرة عبّاد، كأنها شمسٌ تضع كفها على جيدها واقفةٌ تلتقط أنفاسها! كان هذا قبل أشهر تقريبآ، قبل أن يطال منزلنا أحد الصواريخ التي هدمته و لم تبقِ إلا على الجزء الذي فيه الصندوق. و لكنه مكانٌ خطرٌ متضعضع لا ينصح الإقتراب منه حاليآ. ليس من أحد يعلم مشاعري! لم أكن لأفكر لثانية قبل تسلق الأنقاض و الدخول بين الركام لإخراجه.. إنما هيهات و الوصول إلى هناك! شقيقي الأكبر ما زال في دمشق. و هو أعقل من أن تأخذه الحماسة فيما لو قرأ كلماتي هذه.. ففي الصندوق ، في الصندوق بستانٌ كامل!
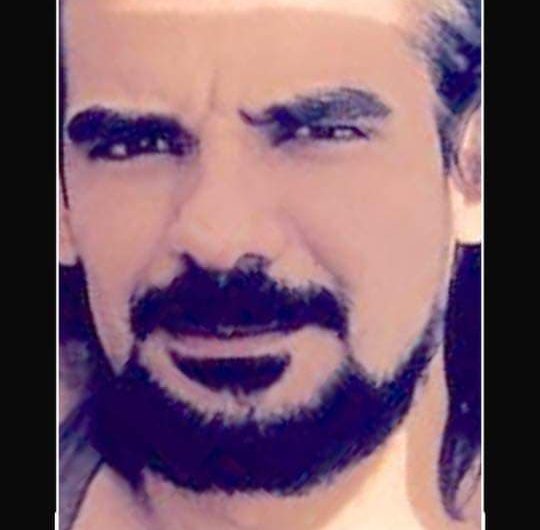
 مخيم اليرموك مخيم اليرموك
مخيم اليرموك مخيم اليرموك



