قيّضَ لي أن أكون من الجيل الذي عايش نهوض العمل الفدائي الفلسطيني وألقه، و شكلت أهازيج المقاومة لنا- نحن أشبال الثورة كما كان يطلق علينا آنذاك بفخر مبالغ فيه -مادة غنية في بلورة وعي بدئي لمعنى فلسطين و الثورة و النكبة, ومازلت أشعر بذات الدرجة من الحماس المجبول بالمرارة كلما سمعت تلك الأغاني ,ولعل أشدها وقعاً ورفضاً للهزيمة تلك التي تقول في أحد مقاطعها: “من قلب الخيمة وليل المنفيين من ذل الوقفة على باب التموين فجرنا ثورتنا على دربها مشينا” ,,, إلخ لا يؤرخن المرء لهزيمته. بل يحتال عليها لتبدو نسقاً “عقلانياً” ضمن سرديته، حيث تقيد الذاكرة آلية السرد لجهة إضفاء الشرعية على مقولات السارد لتبرير هزيمته، فالمهزوم يمتلك عجزاً، ريما فطرياً، عن التفكير والتصرف بلغة الماضي والمستقبل، بينما يخلق المنتصر سرديته،وبالتالي سوف ينكر بكل تأكيد خصوصية المهزوم، ولن ينظر للمهزوم كصانع للتاريخ والذاكرة، بل ربما سيتم نكران امتلاكه حتى للتاريخ، فتاريخه الخاص به ولم ولن يعد ملكه. ولكي يعود للمهزوم تاريخيه يتوجب عليه فتق غلالة الذاكرة وعدم اعتبارها النموذج الحاكم لسرديته التاريخية، فالتاريخ بشكل عام يقدم لنا استنتاجات وملاحظات لا علاقة لسردية الذاكرة فيها وهي مختلفة كليا عما يحتويه خزاننا السردي وجهازه المبني على الرواية الشفوية. ونفي مثل هذا الجدل سيصيبنا في الفشل في التعرف على طبيعة أحداث حياتنا اليومية, نظراً لأن وعي الهزيمة المثقوب يقوم بعملية تشويه واسعة الطيف للذاكرة وتشظيتها وتحريفها، وهو أمر منطقي بطبيعة الحال لاسيما حين نبتعد في الزمن عن لحظة الحدث أو حين انتقال عملية السرد لأجيال أحدث لم تعش الحدث ذاته وهو ما نلاحظه على سبيل المثال في ذكرى نكبة فلسطين، حيث مازال اللاجئون وأبنائهم وأحفادهم يصرون على سردية النكبة كما لو أنها حدثت للتو وهم بذلك يساهمون بطريقة أم بأخرى ببقاء هذه السردية حية نابضة، غير انها ذات أوجه مختلفة، حتى يخال للمرء أنها أكثر من نكبة. غالباً ما يكون الناس مدفوعين بضغط الجماعة في ظل الازمات ،لاسيما السياقات التي تنطوي عليها ظاهرة الحرب أو التهجير لخلق رغبة ملحة للمساهمة في بقاء هذه المجموعة حية عبر نسيج معقد من الذكريات جوهره قصص و سرديات تمت للواقع بصلة ما، وهم لا يصبحون حقا متعلقين جداً بذكرياتهم ما لم تحتضنها مأساة .وعادة، تنتمي جذور السرد إلى شبكة ديناميكية اجتماعية فعالة ترتبط بعلاقات القربى بالدرجة الأولى ثم بعلاقات مشاركة المأساة بحد ذاتها و بالمعيش اليومي وبالجهاز التعليمي التربوي ذو السمات الوطنية-القومية الواضحة….إلخ من الشبكات الاجتماعية ,مما يجعل السردية عرضة للمبالغة و التهويل لا سيما إذا كانت شفوية و غير رسمية مستقلة بكريقة ما عن التأثيرات الإيديولوجية. و من الواضح أن ثمة تحيز معرفي واضح هنا لجهة الافتراض بأن دافع المبالغة في تفاصيل سرد الذاكرة قد يكون “لمعظم الأفراد المشاركين فيها” مدفوعا باعتبارات كبرى. ونظرا لأن المثقفين يرمون إلى أن تكون هذه الاعتبارات ذات دوافع أيديولوجية في المقام الأول، فإنهم يميلون -بالتالي- نحو “تعيين” دوافع ايديولوجية مهيمنة على كل من المشاركين في السردية والناقلين لها و رواتها. علاوة على ذلك، عندما لا يكون هناك ثمة مزاعم من هذا النوع أو ذاك، يتم في هذه الحالة الترويج عبر وسائل التعبير الثقافية التقليدية لشمولية الاستحضار الإيديولوجي وهي لا تختلف في كثير من الأحيان عن تلك التي تستخدمها المؤسسة الرسمية لبناء سرديتها الخاصة. من هنا يمكن القول أن الذاكرة الفلسطينية تبدو غريبه عما حولها ” لنتذكر كلمة تغريبة ووقعها النفسي و الدرامي في نفوس اللاجئين أكثر من غيرهم”. إذ ترتكز هذه الذاكرة على جملة “مطالب” تسعى لتكريسها كنص تاريخي شمولي من خلال العودة لماضي -متخيل أو حقيقي- سردي أو نصي, لبلورة مداركنا و نفسياتنا و سلوكنا على مختلف الجوانب بما في ذلك رؤيتنا للعالم بحد ذاته. علماً أن هذه المطالب ليست مستقلة بذاتها, إذ يشترك فيها “الإسرائيلي/اليهودي/الصهيوني” الذي يدعي ذات المطالب و بذات الدرجة النفسية التي يتمتع بها الفلسطيني . وإذا كان من المستحيل واقعياً وعملياً استعادة الماضي-كما يرى ميشيل فوكو- فيمكن تمثّله على الأقل، وبتوجه مباشر نحو المقصد يمكن القول: ينفرد تاريخ اللجوء الفلسطيني، ومن خلفه ربما تاريخ فلسطين بأكمله بنسق افتراضي غير نقدي ينبع جوهره من قراءة ذاتية تغلب عليها العاطفة و “ذاكرة المهزومين”. والمعضلة التي تواجهنا لفهم سردية اللجوء هي في الآلية المتبعة في قراءة وتفسير وتأويل الذاكرة، من حيث اختيار تقنيات او استراتيجيات القراءة التي تقودنا لتفسير و/أو تأويل النص. وتنطوي مثل هذه الاستراتيجيات على افتراضات يتم تبنيها حول نص ما وسرديته ولغته. كما يدور سؤال مركزي آخر هو لماذا نتبنى في روايتنا هذا النمط أو تلك الطريقة من السرد وليس سواها؟ تلعب مثل هذه الافتراضات دوراً في فهمنا للنص المروي وآلياته سرديه وما قد يعنيه لنا. ونحن ننخرط ، عموماً، في تقنيات القراءة هذه دون وضع حدود معينة أو أطرٍ لها، على أننا نكون واعين لما نقرأ، وهذا ما يخلق أنماطا مختلفة من هذه التقنيات تصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض في قراءة النص الواحد، الأمر الذي من شأنه أن يخلق جدلاً يستقطب في بؤرته التأويل “المرغوب فيه” مما يمهد لنا سبل الدفاع عن قراءتنا (بمعنى موقفنا). وهذا هو، ربما، جوهر تأويل النص، ففيه ومعه تظهر أسباب الخلاف مع الآخرين حول معنى التأويل وغايته.
وباختيار طريقة ما لقراءة سردية النكبة يتولد انطباع مبدئي للمتلقي بحجم المبالغة في هذه السردية، بعيداً عن الأنماط الثقافية الحاملة لها. ولعل ما هو مربك هنا هو الطريقة التي يتم فيها المزاوجة القسرية بين تدوين الحدث التاريخي (النكبة) وتفسير/تأويل هذا الحدث(الهزيمة)، والمحاولة بهما ومعهما (أي التدوين والتأويل) لخلق ذاكرة جديدة ناجزة “مقاومة” وقد يميل البعض-بطريقة متطرفة للغاية-للاستغناء عن الماضي، كل الماضي باعتباره سبباً للهزيمة وتحويله إلى مكب نفايات ممتلئ بسمومها وذكرياتها البائسة. ومن الواضح أن قليلا من هذا السم قد تسرب عميقاً في وعينا. وحيث يتم التشديد على أوجه التشابه الرئيسة بين الناس المشتركين في الحدث , فكثيراً ما نصطدم بتنوعات سردية تشترك في الحبكة المركزية للحدث وهو ما يحيلنا إلى القيام بالبحث عن رمز ما أو رواية متينة أو غيرها لتأويل و دعم حجج السردية المركزية (النكبة) و البحث عن آليات تكيف هذه السردية مع بيئتها الجديدة ( المنافي ) ,فسردية المخيم مثلا ,ذات بنية مركزية جوهرها فعل رمزي “ذكوري” يطمح لإعادة الاستيلاء على الوطن ضمن الإطار العام للنضال الوطني لمجموع للشعب الفلسطيني وهو بذلك يختلف عن سردية أماكن أخرى يعيش فيها الفلسطيني ,كما تؤكد على ذلك الكثير من الأشياء. لعل أهمها، اللغة الخاصة للمخيم والتطور السياسي و الاجتماعي لسكانه, و موقفه من المدينة، وملصقاته و أسماء شوارعه وحساسيته المفرطة تجاه القضايا الأمنية ..إلخ. وربما يتجلى الفعل الذكوري في المخيم من خلال “النزق ” الحاد الذي يميز سكانه، فالمخيم -أي مخيم-هو باختصار التبسيط المعجز في حلقة النضال الوطني والذي لن تكتمل السردية الفلسطينية بدونه بأي حال من الأحوال. لا يقتصر التحيز التأويلي على الفلسطيني، فللإسرائيلي نصيبٌ منه وهو لا يتوقف -أي التحيز-عند أسطرة الحدث، بل يتعداه إلى ما يمكن وصفه بالتحيز في استخدام المتغيرات المختلفة لتفسير السياسات. وسيكون من الواجب علينا إدراك هذا التحيز، فعملية استحضار التاريخ، عبر روايات متماثلة لا تتطلب منا أن نتخيل للحظة ما كل اللحظات التاريخية لتلك الروايات، ويمكن توضيح ذلك بمثال يتم اشتقاقه من العدو “الوجودي” والتاريخي” للفلسطينيين، أي إسرائيل المعاصرة التي بنت سرديتها على متكآت تاريخية متمثلة في مرويات العهد القديم عن إسرائيل “القديمة”. ومن خلال فهمنا لاستخدام المتغيرات لتفسير السياسات يظهر التحيز التأويلي الإسرائيلي في محاولته الحثيثة لبناء “تاريخ متماسك ” يحمل طابع الاستمرارية والتواصل لإسرائيل القديمة. وبناء على ذلك لا يبدو “نسق” تاريخ إسرائيل القديم-كما يرى الباحث في تاريخ الشرق القديم توماس طومسون- تاريخاً بل هو مجرد صياغة عقلانية لإسرائيل التوراتية. وعليه فإن آثاريات فلسطين لم و”لن” تثبت أو تؤكد ولو رواية واحدة من المرويات “التاريخية” التوراتية، بل يمكن القول بأن الأمر يبدو بحسب تعبير جون فان سيترز بأن هناك “افتراض غامض يتبناه علم الآثار التوراتي بخصوص العصور القديمة، مثل هذا الافتراض لا ينبغي استخدامه كوسيلة للبرهان على أن هناك ثمة تاريخ”متصل” لبني إسرائيل منذ أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر “, وبالتالي سيتحدد مفهوم هذا النسق للتاريخ الافتراضي من خلال نظرتنا إلى البنية ككل و ليس من خلال نظرتنا إلى العناصر التي تتكون منها و بها البنية وهو في كل الأحوال ليس معادلاً بسيطاً أو مباشراً لمجسدٍ مادي، حيث نرى نزوعاً واضحاً لجهة إنتاج تواريخ تختزل أو تطّهر الأصول “الغريبة” من تاريخ إسرائيل ليصبح تاريخا “يهوديا” نقيا، يخص أرض الرب و شعب الرب دون سواهم. يعد مفهوم الذاكرة وآلياته السردية إشكالياً من الناحية التحليلية لأنه من غير الواضح ما إذا كان يشير إلى الأسباب والدوافع، أو يشير إلى مسوغات تبريرية، بسبب ميوله في حالات عديدة لتقمص دور الضحية والبحث عن مبررات غير ذاتية للهزيمة .والمشكلة التي تواجهنا إزاء هذه الحالة هي اتجاه السببية. فهل يقوم الناس ببناء حكاياتهم كي يبرروا هزيمتهم أو فشلهم ؟ هل نستغرب أو نندهش حين نتذكر أحداث حياتنا اليومية فتبدو لنا مبالغ فيها؟ أو غير واقعية رغم أنها مستمدة من الواقع؟ وإذا كانت هذه الحالة الأخيرة هي السبب، فإن الدراما -بوصفها عملا ابداعيا يندرج في إطار الفن- قد لا تختلف عن الممارسة السردية المقبولة على نطاق واسع. أم أنها أقل قابلية لمثل هذا التبسيط؟ بكلتم آخر، بلور مثل هذا التبسيط نسقا اقتات منه حركة المقاومة الفلسطينية منه، ولم تزل، من اجل استكمال مهامها الوطنية. فبدلاً من عالم الأبيض والأسود سوف نكتشف سلسلة من المواقف المتميزة، كل منها يمكن أن يستدعي تطوره الداخلي الخاص به. ذاكرة المخيم تقوم على سردية النفي و التهجير و فقدان الارض. بيد أنه بقليل من التمحيص نرى أن هذا ليس لايقتصر على التاريخ القلسطيني دون سواه , فثمة في التاريخ الانساني أمثلة لا تحصى لعمليات تهجير قسري لشعوب تم اقتلاعها من مواطنها و تشتت في أصقاع الارض , بل هناك ثمة ما هو أقسى من ذلك من تدمير و إبادة لشعوب و حضارات بأكملها. إذن الوضع الفلسطيني ليس استثناء و لا هو حالة مميزة, إلا من ناحية اشتراكه بتجارب إنسانية متعددة عبر التاريخ و من خلال امتلاكه لسرديته الخاصة به ولروايته و ذاكرته ولكونه يواجه عدوا “ليس كمثله شيء”, وهذا ما يشكل أحد اكثر الملاحظات ديمومةً واتساقاً في الوعي الفلسطيني.
غير أن واقع الحال يبين أن كل الفلسطينيين “نكبوا”، فنسيج الذاكرة ما زال لم يهترأ بعد والذكريات لا تزال قائمة، وكذلك الأفكار، وإن كان كل ذلك ملغزاً ويظهر بشكل متكرر. وهي،أي الذكريات،تقف مثل كابوس حقيقي يقيد أي شخص يسعى إلى الحقائق فحتى المعلومات البسيطة عن تفاصيل الحدث،أي النكبة، ليس من السهولة الحصول عليها، ويكمن خلف احصائيات الموت عالم يهيمن عليه الغموض و المبالغة و ندرة البيانات و المعطيات الموثوقة مهيمن ، فالنكبة عالم “ضبابي” عالم ما بعد الفردوس. عالم يجعل المرء أحيانا يؤمن بأن الصراع في فلسطين له وجوه عديدة، في جزء منه هو مزيف وذو مخيلة متورمة يقوم على بنيان هش من الأسطرة والتحامل وتضخيم الذات وتبرير الهزيمة ينتقل بطريقة تناصية حصرية من القاعدة إلى القمة مستسلمين لفكرة مريحة ترى في إسرائيل قوم من القتلة المتعطشين للدماء نشروا الرعب والدمار والموت في بلادنا حيث كنا نعيش بوئام ومحبة. أليست هذه الصورة تعكس في جنباتها تحيزا ما؟ ألا تمثل هذه الصورة وجهة نظر النخب الفلسطينية، التقليدية القديمة منها والمعاصرة؟ أليست هذه الصورة هي التي أنتجت مقولة “شعب الجبارين؟”، وقد ساهمت دول ومنظمات وأنظمة على مدى قرن تقريبا في إعادة تدوير هذه الصورة ولم يحاول أحد -إلا من رحم ربي-إظهار ولو بخجل الفجوات هنا وهناك، بل على العكس تماما لقد ساهمنا جميعا في اعتماد هذا التصور، وبطريقة سيئة من خلال رجال دعاية سذّج أعاقوا ومازالوا يعيقوا فهم طبيعة وجوهر الصراع وتناقضاته الأساسية. بعد كل شيء، هذه الصورة ليست خاطئة تماما، وكان لها الفضل في توعية الرأي العام الدولي إلى إعادة النظر في المصير الكارثي للملايين من الفلسطينيين الذين وقعوا ضحية سطو في وضح النهار. لكن هذه الصورة ليست كافية، وطابعها العاطفي يلقي بقناعه على تعقيد وعمق العمليات الاجتماعية والسياسية التي تجري على الأرض والبشر والذاكرة، الأمر الذي يتطلب منا الولوج بعيداً للبحث الدقيق في أعماق ذاكرتنا،. فهناك ، على الدوام، ثمة حيز للشفق في الظلام الذي يتحدى سرديتنا، سواء كانت خاصة أو رسمية
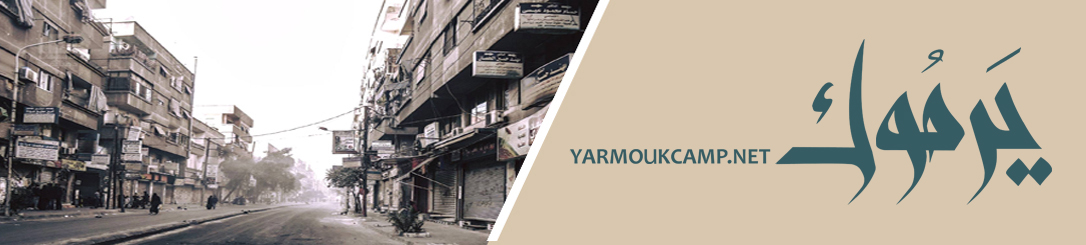 مخيم اليرموك مخيم اليرموك
مخيم اليرموك مخيم اليرموك




